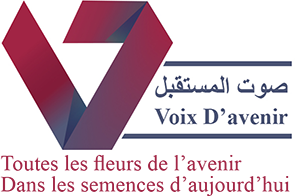يحيى الفخراني في افتتاح أيام قرطاج المسرحية في دورتها السادسة والعشرين
السلطة والهشاشة: “الملك لير” في رؤية عربية
افتتحت أيام قرطاج المسرحية في دورتها السادسة والعشرين بعرض ينتمي إلى ذاكرة المسرح العالمي: “الملك لير”، في نسخة عربية يؤدي بطولتها يحيى الفخراني ويخرجها شادي سرور. إن اختيار هذا العمل لافتتاح الدورة ليس مجرد قرار فني، بل إعلان عن رغبة في استعادة العروض الثقيلة التي تمتحن المسرح في قدرته على مساءلة الإنسان والسلطة والمصير. يقدم الفخراني شخصية لير برؤية تنأى عن تصوّر الملك الصارم، ليميل إلى الكشف عن هشاشة الرجل الذي تتهاوى طبقات سلطته تدريجياً، حتى ينكشف جوهره الإنساني حين يكتشف، متأخراً، أنه أخطأ في قراءة من حوله. أداء الفخراني يستند إلى الإيقاع الداخلي للشخصية، بين انكسار الصوت وتردد القرار وانهيارات تتراكم في جسده ولغته، فتبدو رحلته على الخشبة رحلة إنسان فقد بوصلته لا رحلة ملك ضلّ حكمه.

يحتلّ مسرح شكسبير موقعًا استثنائيًا في تاريخ الدراما، إذ جمع بين عمق التحليل الإنساني وجرأة الطرح السياسي، وبين الشعر الدرامي والبناء التراجيدي المتين. لم يكن شكسبير مؤلفًا يلاحق الحبكات فحسب، بل كان صانع عوالم يتقاطع فيها العقل والهوى، القوة والهشاشة، السؤال الفلسفي والمصير البشري. ومن بين أعماله الكبرى، تبرز الملك لير بوصفها ذروة التراجيديا الشكسبيرية؛ نصًّا يختبر حدود الإنسان حين يواجه سقوطه الخاص، ويعرّي آليات السلطة عندما تُمنح لمن لا يدرك طبيعتها المتقلّبة.
فالمسرحية ليست مجرد حكاية ملك يوزّع مملكته على بناته، بل بناء درامي متشابك يشتغل على مفارقات الحب والولاء، وعلى العمى الرمزي الذي يصيب السلطة حين تُقاس بالمديح لا بالفعل. في الملك لير، تتكثّف الأسئلة الكبرى: ماذا يعني أن يحكم الإنسان نفسه قبل أن يحكم الآخرين؟ وما الذي يبقى من المُلك حين ينسحب عنه العقل؟ وتُصبح الشخصيات، من لير إلى كورديليا إلى المهرّج، أدوات لتفكيك هذا السؤال الإنساني الواسع.
ومن خلال هذا التعقيد، تبدو المسرحية عملًا يختبر قدرة المسرح على قول ما تعجز عنه اللغة اليومية: كشف الحقيقة عبر الانهيار، ورسم صورة السلطة وهي تتداعى، لا لتسقط فقط، بل لتفضح ما كان مستترًا خلف صلابتها الظاهرة. بهذه الروح، يظلّ مسرح شكسبير مرجعًا حيًّا، وتظلّ الملك لير إحدى أكثر مسرحياته قدرة على مخاطبة العصر مهما تغيّر الزمن.
تقدّم المسرحية جماليات سينوغرافية لافتة، تقوم على مراوحة محسوبة بين الرقمي والواقعي، دون أن يطغى أحدهما على الآخر. فالمؤثرات البصرية الرقمية لم تُستخدم بوصفها زينة حديثة، بل كامتداد لمعنى النص، بينما احتفظت العناصر الواقعية بقدرتها على تثبيت الفضاء ومنح الخشبة ثقلها الدرامي. وقد جاء استخدام الألوان جريئًا، ينتقل من العتمة الموحية إلى الإشراق الفجائي، في حركة تواكب التحولات الداخلية للشخصيات: انكسار الملك، مكر الابنتين، ووضوح الحكمة الساخرة لدى المهرّج. هذا التلاعب اللوني منح العرض نَفَسًا بصريًا يتجاوز التوضيح إلى خلق مناخ نفسي كثيف.
كما برزت حركة الممثلين بانضباط ملحوظ، حركة تستثمر المساحات دون فوضى، وتبني علاقتها بالجمهور عبر الإيماءة والإيقاع والسكون المدروس. الأداء في مجمله جاء جيّدًا، محافظًا على التوازن بين الانفعال والتجسيد الواعي لنبرة النص الشكسبيري. أمّا جمالية النص نفسه، فقد أفصح عنها العرض دون أن يثقلها بالتأويل، مقدّمًا نقدًا واضحًا لآليات السلطة عندما تنفلت من الحكمة، وللشرّ حين يتّخذ شكل القرب العائلي والخيانة الهادئة.

وتظل شخصية المهرّج نقطة ارتكاز أساسية؛ فهو ليس مجرّد ظلّ للملك، بل مرآته الساخرة، الضمير الهارب من البروتوكول، والصوت الوحيد الذي يجرؤ على تسمية الأشياء بأسمائها. من خلاله يتكثّف الحكم على السلطة: سلطة تعمي أصحابها، وتكشف هشاشتها حين تُمارَس بلا تبصّر. ومن خلاله أيضًا يتقدم النص بنبرته النقدية الواضحة، مذكّرًا بأن الدرس ليس حكائيًا فحسب، بل سياسي وإنساني في آن واحد.
اعتمد شادي سرور في الإخراج على سينوغرافيا مراوحة الرقمي والواقعي ؛ ضوء محسوب يصنع عالماً خانقاً يتبدّل عمقه مع اشتداد التوتر، وموسيقى ترافق المشهد دون أن تتقدّم عليه. هذا التوجه في العناصر السينوغرافية أتاح للنص أن يظهر في طاقته الأصلية، وللأداء أن يتحمّل العبء الدرامي دون تشتيت، كما جعل الجمهور يتابع المسار التراجيدي بتركيز مضاعف.
تكمن قيمة هذا العرض في قدرته على تحويل الأسئلة القديمة إلى أسئلة معاصرة؛ فكيف تنهار السلطة عندما تُبنى على الوهم؟ وكيف تتحوّل المحبة نفسها إلى امتحان حين تُقاس بالكلمات لا بالفعل؟ إنها أسئلة تتجاوز الزمن الشكسبيري لتلامس المتفرّج العربي الذي يعيش، منذ سنوات، توتراً دائماً بين صورة السلطة وحقيقتها، وبين الخطاب وما يخفيه.
أما الممثلون، فقد شكّلوا شبكة متكاملة أسهمت في بناء التراجيديا دون أن يتقدّم أحدهم على وظيفة دوره. يبرز طارق الدسوقي بحضور صلب ونبرة واثقة تمنح العرض توازناً عقلانياً في مواجهة الانفعالات التي يمر بها لير. ويقدّم حسن يوسف أداءً يقوم على مساحة رمادية بين الخضوع والمصلحة، ما يجعله جزءاً من السياق الذي يسرّع الانهيار. وتؤدي أمل عبد الله ولقاء علي وبسمة دويدار أدوار بنات لير بتباين واضح؛ الأولى تُخفي طموحها القاسي خلف رقة مصطنعة، والثانية أكثر حدّة وتوتر، بينما تقف الثالثة في مساحة الصدق المضيء وسط عالم مضطرب.
إلى جانبهم، يقدّم تامر الكاشف حضوراً قوياً، ويضبط أحمد عثمان إيقاع العقلانية وسط الفوضى، وتُسهم إيمان رجائي في تثبيت التوتر العام، فيما يؤدّي محمد العزايزي دور المنفّذ الصامت للأوامر بدقة لافتة. كما يكمّل طارق شرف وعادل خلف ومحمد حسن البناء الدرامي بأدوار داعمة، لا تقع في نمطية الشخصيات الثانوية بل تمتلك أثرها الخاص في توجيه مسار التراجيديا.
هكذا يتشكل العرض من طبقات متشابكة؛ نصّ عالمي يتجدد، رؤية إخراجية تفضّل الوضوح على الإبهار، أداء جماعي ينهض بتفاصيله الدقيقة، ومشهدية تعتمد على الاختزال لإبراز التوتر الداخلي. ومع بلوغ النهاية، يشعر المتفرّج بأنه أمام مأساة لم تفقد راهنيتها، فأسئلة السلطة والعدل والخيانة والعمى الأخلاقي لا تزال تعبُر العصور، وتجد صداها اليوم كما وجدت في زمن شكسبير. لذلك، يبدو اختيار هذا العمل للافتتاح اختياراً واعياً؛ إذ يعيد المسرح إلى وظيفته الأولى: كشف ما يتوارى خلف الكلمات والصور، والمضي نحو الأسئلة قبل الإجابات.
كان لافتًا ذلك الحضور الكثيف للجمهور، حضور بدا وكأنه يتجاوز مجرد الرغبة في مشاهدة عرض افتتاحي، ليغدو موقفًا جماعيًا معلنًا: رغبة في الاحتفاء بالمسرح نفسه. امتلأت القاعة قبل بداية العرض بوقت طويل، وبقيت كل المقاعد مشدودة لأكثر من ثلاث ساعات دون أن يتسلّل الملل أو التبرّم. بدا الجمهور وكأنّه يدخل مع الملك لير في حوار، يصبر على امتداد السرد، يتابع التحوّلات، ويمنح الممثلين تلك الطاقة التي لا تُكتسب إلا من صالة مهيأة للإنصات.
وفي قلب هذا المشهد، كان عطـاء يحيى الفخراني واضحًا، عطاءً ناضجًا يشتغل على تراكم الخبرة، لا على استعراض المهارة. استطاع، منذ اللحظة الأولى، أن يمدّ جسورًا بينه وبين الجمهور، وأن يفرض إيقاعه الخاص في قراءة الشخصية، ليجعل من الانهيار التراجيدي للملك مسارًا حيًّا يتنفس على الخشبة. لم يكن حضوره طاغيًا بالمعنى المتعالي، بل بالتجسّد الهادئ والدقيق لشخصية تعرف أنها تفقد سلطتها أمام أعين الجميع.

وحين وقف الممثل الكبير مكرَّمًا في ختام العرض، بدا أن لحظة التكريم لم تُكتب له وحده، بل للمسرح العربي وهو يستعيد رموزه أمام جمهور قادر على تقدير هذا الجهد. انفجر التصفيق طويلًا، تصفيق لم يكن مجرد عادة بروتوكولية، بل فعل تقدير صادق لذلك الوفاء للمهنة، وللمرحلة التي جمع فيها العمل الفني بين الصرامة والجمال، بين النص الكلاسيكي وروح الحاضر. في تلك اللحظة، بدا أن الجمهور نفسه هو الذي يكرّم المسرح، بأن بقي واقفًا، مصفّقًا، ممتنًا لهذه العودة الثقيلة بالمعنى والذاكرة.
فوزية ضيف الله
تونس