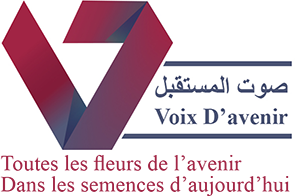“دنيا ليست مفقودة… بل نحن“
مسرحية “كما اليوم” لليلى طوبال في المهرجان الدولي بالحمامات

في عرض استثنائي على ركح المركز الثقافي الدولي بالحمامات، قدّمت ليلى طوبال مساء الجمعة 18 جويلية 2025 عملها المسرحي الجديد “كيما اليوم”، ضمن فعاليات الدورة 59 من مهرجان الحمامات الدولي. هذا العرض، الذي شاركت في إنتاجه “شركة الفن مقاومة” والمسرح الوطني التونسي، شكّل لحظة مسرحية نادرة، استمدت قوّتها من كثافة الرموز وعمق الأسئلة التي يطرحها النص، ومن دقة التكوين الإخراجي الذي نسجته طوبال دون أن تطأ الخشبة كممثّلة، بل كمؤلفة ومخرجة تحفر في المعنى، وتحرّك العناصر من الخلف، بثقة وحساسية.
“كيما اليوم” ليس مسرحية بالمعنى التقليدي، بل أقرب إلى طقس شعري بصري، يقوم على حدث بسيط: اختفاء الطفلة “دنيا” عشية عيد ميلادها الخامس، بعد أن سمعت صوتًا غامضًا يدعوها إلى النزول، إلى “الداخل”، إلى حيث لا يعود الكلام كافيًا، ولا الصور معبّرة. هذا الاختفاء يتحوّل إلى نقطة ارتكاز، تُعيد من خلالها الشخصيات النظر في علاقاتها، وفي الزمن، وفي نفسها. الأم، الأب، الجارة، الفضاء، كلّها تتحوّل إلى كائنات تبحث عن الطفلة، لكنها أيضًا تبحث عن ذاتها.
لقد اختارت طوبال أن تخرج من ذاتها التمثيلية، تاركة المجال لصوت جماعي متعدّد الطبقات والأعمار، تشكّل من خلاله نصًا يكتبه الجسد أكثر مما تكتبه اللغة. وقد أدّى الأدوار مجموعة من الممثلات الشابات، من بينهن مايا سعيدان وأصالة نجّار، بتوزيع حركي دقيق، يعتمد على تداخل المشاهد، وعلى لعبة التكرار والاختفاء، وكأن المسرح نفسه يحاكي فعل الضياع. لا ينحصر العرض في الحكي، بل يتوغّل في الصورة، في الصوت، في الظل والضوء، ليخلق تجربة حسّية يتواطأ فيها المتفرّج مع الفقد، لا ليحلّه بل ليحياه.
لم تكن الموسيقى التي وضعها مهدي الطرابلسي، وأدّتها بصوتها الدافئ عبير دربال، مرافقة بقدر ما كانت لغة مستقلة، تعمّق المعنى وتفتحه على احتمالات جديدة. وكذلك كانت السينوغرافيا: رسم ضوئي بسيط لكن محمّل بالدلالات، عوالم معلّقة بين الحقيقة والحلم، بين الخارج والداخل، تشبه ما بعد الصدمة، أو ما قبل الإدراك.
لعل المثير في العرض أن ليلى طوبال، رغم غيابها جسديًا عن الركح، كانت حاضرة في كل مشهد. لم تكن بحاجة لأن تنطق بجملة واحدة، فقد كتبت وجودها في إيقاع المَشاهد، وفي تفاصيل الحضور والغياب، وفي جرأتها على بناء نص لا يُشبهها فقط، بل يشبه جيلًا بأكمله يبحث عن المعنى في عالم ينهار تدريجيًا. لقد اختارت هذه المرّة أن تكون خلف الستار، كي تتيح للآخرين أن يجرّبوا النطق والسكوت، الألم والحنين.
“كيما اليوم” هو عرض عن اللحظات التي لا تُنسى، لأنها ليست حدثًا بل إحساسًا. عرض عن الأطفال الذين يفقدون أنفسهم، وعن الكبار الذين يفقدون العالم في عيونهم. لا يقدّم أجوبة، ولا يحسم المواقف، بل يتركنا مع سؤال وحيد: أين هي “دنيا”؟ وهل نحن من فقدناها، أم أنّنا نحن من لم نعد نعرف كيف نراها؟ جمهور الحمامات، الذي تابع العرض في صمت متأمّل، لم يكن مجرّد متفرّج، بل شريكًا في تجربة شعريّة عميقة، تدعونا لنفكّر لا في المسرح فحسب، بل في واقعنا، في هشاشتنا، وفي أحلامنا التي اختفت… كيما اليوم.
كانت السينوغرافيا في عرض “كيما اليوم” أحد أعمدة التجربة المسرحية، بل يمكن القول إنها قامت بدور النص الموازي، لا تشرح ما يجري بل تفتحه على تعدد المعاني والانزياحات. لم تعتمد على الزخرف أو الإبهار، بل على اقتصاد بصري دقيق، فيه حضور للأثر أكثر من الشيء، وللظل أكثر من الشكل.
المساحة الفارغة لم تكن خواء، بل محيطًا للضياع، مجالًا مفتوحًا لاحتمالات الحضور والغياب. الألوان خافتة، مُترددة أحيانًا، كما لو أنها تتهيّب الإفصاح عن المأساة. الإضاءة نُسجت بعناية لترافق تغيّر الإيقاع الداخلي للشخصيات: الضوء لا يسلّط على الممثلين فحسب، بل يلاحق ذاكرتهم، يُضيء الخوف، ويكثّف لحظات التوتّر والانكسار.
تتحرّك الأجساد الموزعة على الركح في خطوط هندسية واضحة، تتصادم أحيانًا، وتنعزل أحيانًا أخرى، كأن الركح نفسه يتحوّل إلى خريطة نفسية. كلّ تفصيلة كانت مدروسة: المقاعد، الأبواب، المرآة، حتى الفراغات التي تُركت عمدًا، كانت تقول شيئًا عن الفقد، عن المسافة بين الذات والعالم، عن الطفلة “دنيا” التي اختفت فجأة، وعن تلك الطفولة التي يُخشى الحديث عنها.
السينوغرافيا، إذًا، لم تكن إطارًا للعرض، بل كانت لغة العرض نفسها: لغة غير منطوقة، تُقاوم التفسير المباشر، وتبني مع المتفرّج علاقة تأملية، تُطالبه بالصمت، بالمشاركة في التيه، وبالقبول بأنّ بعض الأشياء لا تُفهم بل تُعاش.
في عرض “كيما اليوم”، لعبت الملابس والألوان والعناصر الرمزية مثل الفراشات دورًا مفصليًا في بناء الدلالات البصرية والنفسية للعرض، وامتزجت بانسيابية مع السينوغرافيا لتُضفي على المسرح طبقات إضافية من المعنى والتأويل.
اختيار الملابس كان مدروسًا بعناية، كأنها خرجت من خزانة الحياة اليومية، أو كأنها بقايا من ذاكرة قديمة، من فيلم، كحديقة ملونة .كانت الشخصيات ترتدي ما يميزها فرديًا، رغم انها تشترك في همّ جماعي ملون، في حزن موحّد، يُوحّدها أكثر مما يفرّقها. تلك البساطة الظاهرة كانت جزءًا من لغة الجسد نفسها، جزءًا من الصمت ومن الثقل النفسي الذي يحمله العرض.
أما الألوان، فقد خضعت لنظام بصري صارم، يعتمد على الالوان الصارخة وكأن المشاهد كلّها تجري في عالم بين الحياة والموت، بين الوعي والحلم. الأبيض، عندما حضر، لم يكن رمزًا للنقاء بل للغياب. الأزرق، حين ظهر، كان ظلًّا للحزن، لا لونًا للسماء. كل لون بدا وكأنه يحكي جزءًا من قصة “دنيا” التي اختفت، ومن أثرها العالق في الأشياء من بعدها.
وسط هذا النسق البصري الكتيم، جاءت الفراشات كعنصر كاشف ومفاجئ. لم تكن مجرد زينة أو ديكور، بل حملت رمزًا ثقيلًا: التحوّل، الطفولة، الحياة الهشّة. ظهورها في العرض كان مثل ومضة حلم أو خيال، لحظة اختراق للشجن العام، وربما إشارة إلى أن “دنيا” لم تختفِ تمامًا، بل تحوّلت إلى شيء آخر، إلى شكل من أشكال الحضور غير المرئي. الفراشات هنا كأنها أرواح خفيفة، تُحلّق فوق الخراب، أو تنذر بهدوء بأنّ النهاية ليست نهاية.
باختصار، كانت الملابس والألوان والفراشات جزءًا لا يتجزأ من المعمار الرمزي لـ”كيما اليوم”. أدوات صامتة لكنها فاعلة، تكتب على الركح بلغة لا تعتمد الحروف، بل النبرة والملمس والظلّ… لغة تشبه الطفلة “دنيا” التي مرّت من هنا، ثم رحلت، وربما لم تغادر أبدًا.
في “كيما اليوم”، لا تبدو الطفلة دنيا مجرّد شخصية اختفت من مسرح الحكاية، بل رمزًا فادحًا لفقدان المعنى وتصدّع الإنسانية في زمن مرتبك. اختفاؤها ليس لغزًا بوليسيًا ننتظر حله، بل سؤال وجودي مفتوح: ماذا يعني أن تغيب الطفولة؟ أن يختفي البراءة من حياتنا؟ دنيا هي كلّ ما أضعناه دون أن ننتبه — الحلم، الثقة، الوضوح، القدرة على الفرح البسيط. لذلك فإن ضياعها هو أيضًا ضياع الإنسان المعاصر وسط صخب العالم وانهيار القيم. تنجح ليلى طوبال في تحويل هذه الطفلة الغائبة إلى مركز للجاذبية الرمزية: كل شيء يدور حولها، لكن لا أحد يراها. تمامًا كما تدور الإنسانية حول مفاهيم كبرى – الحرية، الحب، الأمل – دون أن تلمسها حقًا. دنيا ليست فقط شخصية مسرحية، بل علامة استفهام حيّة، تختبر من خلالها طوبال هشاشتنا ككائنات فقدت طريقها، ونسيت أن تسأل: أين ذهبنا جميعًا حين اختفت دنيا؟
ريم خليفة
الحمامات 18 جويلية 2025