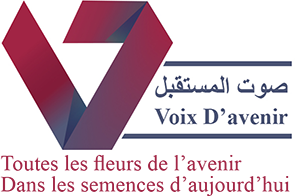“أمّ البلدان”: ركحٌ يهتزّ بأسئلة لا أجوبة لها
بين المثقف والمفكر والمواطن والسلطان : أدوار متشابكة على ركح مأزوم
في فضاء الحمامات الذي يشتبك فيه عبق التاريخ برهبة الأسئلة المعاصرة، جاء عرض مسرحية “أمّ البلدان“ يوم 16 جويلية 2025 ضمن المهرجان الدولي بالحمامات في دورته الـ 59 ، ليوقظ شجنًا طويلًا في ذاكرة المتفرّج التونسي. إن العمل الذي أخرجه حافظ خليفة عن نصّ للكاتب الكبير عزّ الدين المدني، ليس مجرّد استعادة لماضٍ سلطاني، بل هو إعادة صياغة جريئة للعلاقة المتوتّرة بين السلطة والشعب، بين التاريخ والراهن، وبين الخطابة الجوفاء والحدث المسرحي الحيّ.
مسرحية “أم البلدان”، نص الكاتب المسرحي الكبير عز الدين المدني، سينوغرافيا واخراج حافظ خليفة، بدعم من الصندوق الوطني للتشجيع على الابداع. كان عرضا مميزا امتزج فيه التاريخ بالنقد، والفرجة باللوعة، والهزل بالجدّ. استحضرت المسرحية التاريخ بلغة الحاضر الراهن وفضحت بهزل ساخر وفرجة مقنعة ودعت المشاهد الى التساؤل عن وضعيات مختلفة مرت بها “أم البلدان” شملت واقع الحكم، الفن والثقافة والعمارة، الفكر والشعر والأدب، علاقة الراعي بالرعية، علاقة الدين بالدولة، ورسمت تونس الأمس البعيد، زمن حكم السلطان أبو زكريا الحفصي، وتونس الآن حيث تتكاثر التساؤلات، في كل ركن. طرحت المسرحية تشخيصا فنيا جماليا، لوهن عربي، وعالجت التاريخ المتراكم معالجة جمالية، من روح الموسيقى ومن روح التراث التونسي والموروث الغنائي، على وقع لوحات كوريغرافية صمّمتها شيماء العوني، لتحاكي ملامح الوجع والفرح والبكاء والتشظي والضحك العبثي أيضا.
تجدر الاشارة الى أنّه قد مرت سنوات على صدور نصّ “أم البلدان” لعز الدين المدني، تحت عنوان “تونس…يا أم البلدان” سنة 2019، عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) بمناسبة تونس عاصمة للثقافة الاسلامية. وقد نال المخرج حافظ خليفة شرف تخصيص جانب من الكتاب لمقاربته الاخراجية والتمثيلية لهذا النصّ بمشاركة الفنانة المتميزة آمال الصغير المختصة في تصميم الأزياء المسرحية.
ويعتبر الكاتب المسرحي عز الدين المدني علامة من علامات المسرح العربي، وقد رشحه “بيت الجكمة” سنة 2019 لجائزة نوبل للآداب، لتميز مسيرته الأدبية. وتعتبر مسرحياته التي كتبت منذ الستينات، مرجعا فكريا وتاريخيا، نذكر منها “ثورة صاحب الحمار”، “رأس الغول”، “ديوان الزنج”، “مولاي السلطان الحفصي”، “تعازي فاطمية”، ” الغفران”، “التربيع والتدوير”، “رحلة الحلاج”، وقد تعامل في مسرحيات أخرى مع المخرج حافظ خليفة فقد أخرج له “عزيزة عثمانة” و”رسائل الحرية” الذي افتتح الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي يوم 10 جويلية 2019. وافتتحت كذلك الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية سنة 2019.
يس من اليسير الاشتغال على نصوص المسرحي عز الدين المدني، ولكن المخرج حافظ خليفة دأب على طرق أبواب موصدة أو لا تفتح بيسر أمام غيره، من جهة ايمانه بعد الاكتفاء بماهو سهل ومتعود عليه ومتكرر. لذلك عرف باخراجه لنصوص متميزة، ايمانا منه بقيمة النص في العملية المسرحية، وعدد هذه المساعي البحثية، عائدا في كل مرة إلى كاتب مسرحي مختلف وجاد. لكنه يعود في هاته المرة لنص فريد لعز الدين المدني الذي عرف بمحاورته النقدية والذكية للتاريخ. تبدو العودة لنص “تونس..أم البلدان” مغامرة تملؤها القصدية ويشحنها العتاد المسرحي للمخرج الذي يسافر نحو أماكن عديدة في العالم للاطلاع على تجارب مختلفة وتطوير رؤيته الاخراجية معرفيا وإجرائيا.
إن ما يحسب كذلك لتجربة حافظ خليفة هو تمرّسه على الاشتغال بالفضاءات المغايرة، الى جانب العلبة الايطالية، وهو ما تجلى في ادارته واستنباطه لفكرة للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، للقطع مع مفهوم العرض التقليدي في الفضاء المغلق، وتطويع كل العروض حسب الفضاءات والأمكنة المتاحة. اضافة الى تجاربه في اخراج الملاحم المسرحية الكبرى التي يتداخل فيها التراث بالتاريخ وبالموروث الشفوي والغنائي، دون التغافل طبعا عن تجربته في الاشراف على ملاحم أخرى بالصحراء الموريتانية عرضت بمهرجان ليالي المسرح الصحراوي بالشارقة. كل هذه النقاط هي ضرورية لفهم سياق المرحلة الحالية التي يشتغل ضمنها المخرج حافظ خليفة مع فريق متكامل ومتعاون يضم ثلاثة أجيال على الأقل وثلة ومن قامات المسرح التونسي، ويجمع بين كفاءات مسرحية وموسيقية وكوريغرافية.
ينطلق العرض من شخصية أبو زكريّا الحفصي، مؤسّس الدولة الحفصية، لكنّه لا ينزلق إلى التوثيق أو التمجيد، بل يوظّف تلك الحقبة كمسرح رمزيّ لمساءلة الدولة الحديثة، وفضح تشقّقاتها المزمنة بعد “عشرية الخراب” التي أعقبت الثورة. يقدَّم السلطان هنا بوصفه مرآة للراعي الغائب، للحاكم المرتبك، ولمؤسسات تتهاوى تحت ثقل الارتجال والجهل، أكثر من كونها شخصيات قائمة بذاتها.
جاءت الرؤية السينوغرافية رقمية هذه المرة متوافقة مع الايقاع الدرامي للمسرحية، ومع الايقاع الموسيقي المرافق. كانت عملية البناء تحدث في الفضاء من خلال السينغرافيا المتحركة والمتلونة، التي تظهر معالم من المعمار التونسي، وكانت الحركة السينغرافية متلائمة مع الموسيقى المصاحبة، الحية أو التصويرية، فرافق ضرب الطبل والدفوف كل اللوحات الكوريغرافية كما رافق لحظات التوتر والوجع أو الفرح.
لذلك انفتحت المسرحية على قرع الطبول احتفالا وإيذانا بالشروع في بناء تونس حجرا على حجر. ومن وسط الظلام تنشدّ الآذان الى صوت بدوي شجيّ، يليه القاء شعري ترافقه إيقاعات الطبل. تحيل هذه البداية إلى خفقان الارادة المؤسسة وشجن الشروع في البناء، فتتقاطع مشاعر الحماس والتحدي وتتوضّح اللوحة رويدا رويدا حتى تظهر صورة السلطان شاحذة للهمم وتتناوب الأصوات المرافقة لصوته على الاعلاء من شأن المشروع والعزم على تشييد تونس في رفعة وعزة وتعاون. كانت مراسم الاحتفال بالبناء من خلال اللوحة الكوريغرافية التي صممتها شيماء العوني، متكونة من ستة عناصر (شيماء العوني، هيثم البوغالمي، ياسين القاسمي، نورة الخماسي، سلمى بهلول، حليمة الدريدي)، على وقع موسيقى تصويرية لرضا بن منصور وموسيقى حية لإبراهيم بهلول. اختارت مصممة الملابس آمال الصغير ألوانا ترابية شحنتها بروح عتيقة لتواكب زمان الحضارة الحفصية، وأضافت لها لمسات تونسية. كان لهذه اللوحة الكوريغرافية دورها في الاشعار بمرحلة البناء التي تميزت بالعدل والإنصاف والحكمة والتروي كما كان لها أيضا الدور الفرجوي الجمالي الذي يعكس حالة الفرح والازدهار الذي عرفته البلاد زمن أبي زكريا الحفصي، فكان إيقاع اللوحة والملابس مناسبا مع الايقاع الدرامي للعرض، كما جاءت السينوغرافيا رقمية هذه المرة تصور مراحل البناء والتشييد وتستعرض في كل مرة معلما من المعالم المعمارية لتونس.
تظهر شخصية “حاحا” المعارض (المتمعّش من المعارضة) جالسا وسط الركح، تزامنا مع انسحاب تدريجي للكوريغرافيين، محذرا من الاستبداد والطغيان، صحبة الحاشة، يتجادل مع “رقراقه” الموالي للسلطان (جميلة كامارا)، فيحدثان مساحة من الهزل الساخر، في حين تظهر الحاشية الموالية للسلطان منتشرة في فضاء الركح، متنقلة هنا وهناك، بملابس فضفاضة واسعة ومشعة، تنير عتمة الأجواء. يظهر السلطان محاولا تهدئة الامر، يدعوهم الى المودة والتفاهم الاستقامة والى التفكير سوية في طرق بناء تونس اليوم والغد، لتكون دولة منيعة تُضرب بها الأمثال، وتتميز بحرية المعتقد وحرية التعبير. فهي استئناف لدولة ملوك بني خراسان، ودولة صنهاجة، ودولة الأغالبة.
تلتقي الشخوص داخل الفضاء بعد وضعية التناظر والتقابل، على نقطة البناء، فيما يظل “حاحا” المعارض بعيدا عنهم، يتأفّف ويتوعّد ساخرا. ولا تنفع فيه محاولات التهدئة. بعد اشعارات الخطر التي تداهم البلاد، يأمر السلطان الحفصي بالتصدّي لكل الأخطار المحدقة في أي شبر من البلاد. وينجح في التصدي لكل المحاولات التهديمية، الاحتلالية أو الارهابية. وتجدر الاشارة إلى أن الملابس والاكسوارات أظهرت الشخصيات في هيبة ووقار حقيقي، يعكس فعلا تاريخيتها وفاعليتها في الحكاية المروية، وأعادت المشاهد الى زمان الفعل الأصلي، بعيدا عن الفعل الدرامي الذي يدور على الركح. وتنوعت التصميمات من لوحة الى أخرى، فتلاءم تغييرها مع مسار العرض ومسار الرقص الذي جمع بين الرقص الكوريغرافي، الرقص الصطنبالي، وكذلك رقص التنورة، في مراوحة بصرية وموسيقية لا تخفي دلائل الوجع ضمن ضمان الفرجة الجمالية وتوظيف التراث الموسيقى التونسي والعربي والإفريقي لاجل مسارات انسانية وكونية. وظلت المرافقة الموسيقة الحية حاضرة على الركح كأنها تعطي الاشارة في كل مرة الى توقيت الزمان الراهن، فتُعيد المشاهد الى وقائع حدثت فعلا في تاريخ تونس الماضي وتحدث الآن بين الفينة والأخرى، كأن قرع الطبل ليس مجرد اشارة الى البداية في البناء ولكن ايضا تحذير من محاذير أخرى تضايق وضع تونس المجيدة، تلك هي الدلالة السيميائية لقرع الطبول منذ القدم، إشارة الى الحرب أو السلم، علامة على الاحتفال أو تحذير من الأخطار. لأن ضربات الطبل تتواشج مع دقات القلب، الذي اما أنه يهتز فرحا أو يهتز خوفا من قدوم الخطر.
تم استعمال الخلفية لعرض ثيمات العرض المسرحي، فكانت الصور المنعكسة اما دالة على مراحل البناء والتشييد أو دالة على مناخات الانهيار والوجع بعد وفاة أبي زكريا الحفصي وتولي ابنه المستنصر بالله الخلافة وانغماسه في الملذا أضفت سينوغرافيا “الغربان” الطائرة على لوحة “الوجع” معالجة سيكودرامية، فخاطبت ذاكرتنا ورسمت معالم الموت الذي حطّ على هيئة غربان حمراء، عكرت سماء تونس، وعطّلت منافذ الحرية، وحلّ اعتقال وسبي النساء والفتيات. في مقابل ذلك يتصدّى أبو زكريا لهذا الطوفان، ويتوعّد الارهابين الذين يطلبون منه خلع نفسه عن الامارة وتسليم عروس المغرب الكبير “تونس” بملاحقتهم في جحورهم حتى الموت.
تظهر لوحة “يا وجعي” من جرح المعارك الظالمة التي خاضها الأب، وكانت بناته هن الضحيات، كما لو أنه أنجبهن للحرب والاغتصاب والزنا والتشفي والهلاك. باسم الجهاد وتحت رداء بطولة الارهاب. كان الأب عدوانا للحياة، عدوانا للفرح وللأبوة، مدعيا أنه وكيل الله في الدنيا أو هو وسيط بين الانسان والرب. تظهر النساء معتقلات، تتناظر أقواس السلاسل في أيديهن، مع أقواس “الحنايا” في خلفية الركح، وتحت كل امرأة جعجعة رحى الغضب وطنين السلاسل المدوّي والخانق. ترتدي النسوة السواد، ينبعث من تحتهن ضياء بسيط، يحدّد بؤرة الخطر والهلاك. تشن النسوة الأسيرات محاكمة مجازية للإرهاب، هي محاكمة للأب، ولكل الهيمنات التي اعتقلت النساء باسم الدين وتحت لواء الشعوذات البهيمية. وتصرخ كل واحدة منهن مُعبرة عن نكرانها لتلك الأبوة، لذلك الانتماء البيولوجي الكاذب، وتُبعد عن تونس كلّ رغبة في ضمّها لخارطة الارهاب والإرهابيين. لكن أبا زكريا كان لهن وليا وراعيا، وشيد لهن قصرا منيعا في قلب تونس قريبا من “باب بنات”.
يظل الظلام عائما، يعبره الأزرق في خفوت، ولكن حدّة الوجع تجعل من اللوحة محاكمة كونية لكل الضمائر النائمة، وتلك الآهات المنبعثة من أفواههن بمثابة شهادات حية ضد مغتصبي الحياة في العالم.في ذاك السواد الحارق، تظهر معالم الاقتدار في صيغ أنثوية متعددة، تضاف لها إرادة زوجة أبي زكريا (عزيزة بولبيار) التي تعلن إسلامها وتشييدها لمدرسة للعلم والمعرفة والابتكار والإبداع، وينتصر أبو زكريا للفكرة ويعلن مجانية التعلّم والتعليم. ثم تستمر زوجته في التصدي للمفاهيم الخاطئة للحرية ويعضدها في ذلك الشاعر الأندلسي “ابن الأبار” (آدم جبالي) وتأتي مناصرته للحرية الحق شعرا وقولا، إلى أن يأتي حتفه وتصفيته في زمن المستنصر بالله وتُتلف كلّ مؤلفاته.
كانت الاختيارات الموسيقية منسجمة مع الأطوار النفسية التي يُحيل عليها ايقاع الأحداث، ويصل الى مسمع أمير البحار صخب الحاشية وعراكها، وتتعقّد مأمورية فك الحصار على الأندلس وسط تغلل الحزن والسّواد، والتسابق على المناصب وتجويع المساكين ومحاصرتهم. ولا يظهر الا بصيصا ضئيل من الضوء الأزرق الخافت. وتفتح تونس أبوابها مستقبلة أهل الأندلس المهاجرين بأعدادهم الغفيرة. يتولى الشاعر الأندلسي ابن الأبّار إخبار أبي زكريا بضرورة انقاذ اشبيليا وبالينسيا من بطش الطغاة. فيكرمه بإقامة دائمة بالقصر ويأمر بإرسال المؤونة والسلاح.
تحضر لوحة الحريف (كمال زهيو) وبائع الخيول والأحمرة، وسط المسرحية راسمة ضروبا من السخرية السوداء، فيتمّ اعتماد استعارة الصور وأقنعة الحمير التي تختلف رُتبها، لنقد بعض مظاهر الانحدار والتدني في المجتمع والإدارة مثل انتشار الوشاة والوساطات والرشاوي ومراعاة المصالح الشخصية. وقد قُدّمت اللوحة بأسلوب هزلي خفيف لكنه عميق في دلالاته الايحائية. فيفتضح أمر البائع الذي يبدو في الظاهر بائعا للأحمرة والخيول، في حين أنه بائع للجواري. وتنغلق اللوحة على رقصة الحمار على أنغام تراثية صحراوية.
وكما كانت الكوريغرافيا للاحتفاء بالبناء والتشييد، تتحول بعد اعلان أمير البحار وفاة أبي زكريا الحفصي، إلى نعي وتأبين. وترقص الأجساد ووتتمايل خصائل الشعر (النخّان) على ايقاعات الشجن والحزن التي تكون أقرب الى الصفير والأنين والبكاء. ووسط عرض “الصطنبالي” يكون الجدل حول مفهوم الثورة والفوضى، ويتحول الجدل الى خصام بيم أعضاء مجلس الخمسين، فيما يستمر الرقص الصطنبالي، كأنه ينبئ بالتحرر والحصول على الحرية الحق لا الحرية المزعومة. يتداخل الجدل بالرقص ثم بالشعر وبقهقهات الجوار، في حين يعلن ابن عن الأبّار سقوط بغداد تحت ضربات هولاكو ولا أحد يُحرّك ساكنا بعد. لكن المستنصر بالله، الذي خلف أبوه يسير بالحكم نحو الهاوية باختياره طريق الملذات والشهوات.
يصدر بعد الفراغ نحيب كأنه فحيح الأفعى أو سريان النار في الهشيم ذات ليل دامس، يتخبط فيه الشاعر والمثقف والمبدع، رغبة في الخلاص. لا أحد ينصت الى تلك الانذارات، غير الكون، إنه خريف الدولة، بعد القوة والاقتدار والنتصار. ربّما تبشّر الأمطار بقدوم ربيع ممطر، لكن الأمطار القوية قد تجرف كلّ شيء. وعندما يحضر الشاعر، ينثر كلماته المتفائلة وسط شحوب الأرجاء، تظهر أعضاء المجلس الخمسين، متحسرين على زوال النعم التي وضعها أبو زكريا. ليستخلص “حاحا” أن المستنصر بالله لم يتحرر من هيمنة الفقهاء الذين كان محاطا بهم، ولم يعلّموه الا الاسلام الشعبوي، اسلام التهديد والوعيد، اسلام التحذير من عذاب القبر وسؤال الملكين لذلك كان أقرب الى رمي الخصوم بالإلحاد وتوعدهم بالقتل. تتزين لوحة الخريف بالمطريات الشفافة، تاركة امكانية انعكاس الأضواء ، ودلت دائرية الاكسوارات ودائرية الايقاع الحركي للممثلين داخل الفضاء على خلقة مفرغة، حالة اختناق تصل اليها الدولة. وينتهي المسار بالشاعر الأندلسي “ابن الأبار” الى مصير مأساوي، فاتلفت كل كتبه ومؤلفاته، وهو مصير كل مبدع حقيقي في دولة ظالمة لا تحترم مثقفيها ومبدعيها.
وتعود المسرحية على البدء، على ايقاع الطب، مستعرضة مشهد تعذيب وقتل الشاعر “ابن الأبار”، ويتعالى الصراخ وتتشنج النفوس وتنشر الحمرة الدامية في الأضواء وتنعكس على الملابس دالة على طغيان الجهل والموت. هكذا يستثقل “حاحا” (جلال الدين السعدي) الدور الذي مثله ويطلب من المخرج (حافظ خليفة) دورا خفيفا لا نقد فيه ولا تجريح “فهذا الزمان زمان المصاعب على المفكرين الأحرار”.
في قلب “أمّ البلدان“، لا تظهر الشخصيات بوصفها تمثيلات فردية فقط، بل كمواقع رمزية داخل نسيج الدولة المأزومة. المثقف يبدو حاضرًا عبر اللغة، عبر السخرية، وعبر التعليق الموارب على السلطة. إنه ليس شخصية مُمأسسة، بل شاهد مريب، يعرف ولا يتكلم بما يكفي، أو يتكلم دون أثر. يُجسّد ذلك المثقف الذي يحمل وعيًا مكسورًا، ويقف على الهامش بين التواطؤ والعجز.
أما المواطن، فيُستحضر بوصفه الكائن الأكثر هشاشة في هذه الدولة. مواطن يتأرجح بين الطاعة والسخرية، بين الجهل القسري والمعرفة المبتورة، بين التبعية العمياء والتمرّد غير المنظّم. هو شخص تائه في خطابات السلاطين، ويبحث عن خلاص شخصي في غياب مشروع جمعي.
في المقابل، يُلمح العرض إلى المفكر بوصفه احتمالًا لا فعلاً. المفكر لا يظهر جسدًا على الركح، لكنه ينسرب في الأسئلة، في الانقطاعات، وفي الفراغات. إنه الغائب الكبير الذي يُفترض أن يحوّل المعرفة إلى تغيير، لكنه غائب – إمّا مغيَّب أو منفي أو صامت. فهل يعكس العرض موت المفكر في زمن الارتجال السياسي؟ أم هو دعوة لإعادة حضوره خارج أبراج العزلة؟
بهذا، تتحوّل المسرحية إلى فضاء جدليّ تتقاطع فيه المعرفة بالعجز، والموقف بالسخرية، والمسؤولية بالتهرّب. عرض لا يعفي أحدًا: لا الحاكم، ولا المحكوم، ولا من يفكّر بينهم.
أمّ البلدان“، لا تُقدَّم السلطة كمجرد هيمنة سياسية، بل كبنية رمزية متوغلة في اللغة، والدين، والعقل. ضمن هذه البنية، يبدو المثقف كمن عرف كل شيء، ورأى كل شيء، لكنه أفرغ معرفته من الفعل. هو واعٍ، ساخر، يراقب انهيار الدولة كما لو أنه مشهدٌ درامي لا يخصّه. هنا يطرح العرض سؤالًا حادًّا:
هل اكتفى المثقف بدور “الشارح”؟ وهل تحوّلت الثقافة إلى ملاذ للتهرّب بدل أن تكون أداة مقاومة؟
في المقابل، يُسائل العرض ضمنيًا أخلاقيات الفرجة ذاتها: هل يجوز للمتفرّج أن يضحك وهو يرى نفسه ممزّقًا على الخشبة؟ هل صرنا نستهلك هشاشتنا كما نستهلك عرضًا مسرحيًا؟ كأن “أمّ البلدان“ تدعونا لا لمشاهدة حكاية، بل للتورّط فيها، للتوقّف عن الضحك، والبدء بالسؤال عن موقعنا نحن – لا فقط كمتفرجين، بل كمواطنين، كمثقفين، كمشاركين في صناعة ما نراه ينهار.
بهذه الحدة، يصبح العرض أكثر من مسرحية. يصبح محكمة رمزية، يحاكم فيها الجميع: من نسي الذاكرة، من صمت، ومن سخر، ومن تخلّى عن مسؤوليته في لحظة كان عليه أن يقول “لا”.






ام البلدان، نص عز الدين المدني
سينوغرافيا واخراج حافظ خليفة
تمثيل: عزيزة بولبيار، جلال الدين السعدي، محمد توفيق الخلفاوي، نور الدين العياري، عبد الرحمان محمود، جميلة كامارا، نزهة حسني، شهاب شبيل، كمال زهيو، آدم الجبالي، عبد القادر الدريدي، فاطمة الزهراء المرواني، عبد اللطيف بوعلاق، عبير بن صميدة، احمد روين، شيماء السماري، مجدي محجوبي، محمد بن يوسف بن عزيز، سيف الدين الوجيهي.
آداء كوريغرافي: شيماء العوني، هيثم البوغالمي، ياسين القاسمي، نورة الخماسي، سلمى بهلول، حليمة الدريدي.
تصميم الملابس: آمال الصغير
موسيقى تصويرية: د. رضا بن منصور
موسيقى حية: ابراهيم بهلول
كوريغرافيا: شيماء العوني
مساعدة مخرج: نزهة حسني
ريم خليفة
الحمامات، 16 جويلية 2025