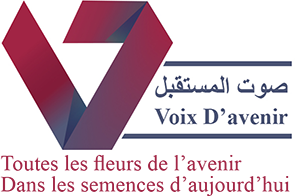“رَست والسارة، صوتٌ من المنفى، وصرخة من الداخل: عرضان في مرايا الهويّة”
في واحدة من أكثر سهرات مهرجان الحمامات الدولي 2025 تميّزًا، اعتلت فرقة رَست إلى جانب الفنانة السودانية السارة وفرقتها النوباتونز ركح مسرح الهواء الطلق بمهرجان الحمامات الدولي في دورته الـ 59، في عرضٍ موسيقي مشترك جمع بين ضفّتين فنّيتين: الروح التجريبية الآتية من المشرق، والإيقاع النيلي المتجذّر في إفريقيا.
افتتحت السهرة فرقة “رَست” بايقاعات تدغدغ طبقات الصوت والذاكرة، بموسيقاها التي تمزج بين الروحاني والتجريبي، وبين الشعر والنغم، فلامست في مقطوعاتها أبعادًا فلسفية وإنسانية عميقة. اعتمدت الفرقة على التدرّج الصوتي والتكثيف الشعري، لتخلق تجربة استماع تتجاوز الطرب نحو التأمل، وتنقل الجمهور إلى فضاءات داخلية مشحونة بالأسئلة والانفعالات.
فرقة “رَست” موسيقى على تخوم الصمت والانفجار:
“تعدّ “رَست” فرقة موسيقية تجريبية تأسست في تقاطع جغرافي وإنساني بين سوريا ولبنان، تحمل في صوتها صدى الضياع والحنين، وفي إيقاعها توقًا مستمرًا نحو التحرّر. لا تنتمي “رَست” إلى تصنيف محدد، فهي تتجاوز الحدود الموسيقية التقليدية، وتمزج بين الشعر، والموسيقى الصوفية، والإلكترونية، والتأملات الصوتية في تجربة فريدة تشبه طقسًا حيًّا أكثر منها عرضًا.
تعتمد الفرقة على الارتجال المدروس، والتصعيد التدريجي في البنية الموسيقية، فتنتقل بسلاسة من الهمس إلى الانفجار، ومن العبارة الشعرية الهامسة إلى الصرخة الجماعية. في موسيقاها، يمتزج الحاضر بالمنسي، وتصبح اللغة أداة صوتية بقدر ما هي وسيلة تعبير. رَست” ليست مجرّد مشروع فني، بل رؤية موسيقية معاصرة تسائل الواقع، وتحتضن هشاشة الإنسان الحديث، وتخلق مساحة استماع حرة، تنفتح على الحيرة، وتحتفي بالارتياب كجزء من جمال التجربة الفنية.
نغمات من الشرق، أصداء من المستقبل:
في تقاطع نادر بين التراث والحداثة، قدّم الثنائي “رَست”المكوَّن من اللبنانية بترا الحاوي والسوري هاني مانجا، ليلة 15 جويلية بالمهرجان الدولي بالحمامت في دورته الـ 59 تجربة موسيقية جريئة تمزج بين الطرب العربي التقليدي والإلكتروني التجريبي، حيث تتحوّل المقامات الشرقية إلى فضاء صوتي مفتوح، ينكسر فيه الإيقاع، وتتماوج فيه الأنفاس مع الذبذبات الرقمية.
ليست “رَست” محاولة لإلباس القديم لباسًا جديدًا، بل هي عملية تفكيك وإعادة تركيب للذاكرة الموسيقية، حيث يُعاد استدعاء الصوت الطربي بوصفه مادة خامًا، يتم تحريره من قوالبه الكلاسيكية، ليُزجّ به في فضاءات صوتية غير مألوفة، تتداخل فيها الآلات الشرقية مع الموجات الاصطناعية، والشعر مع الصمت.
تعتمد الحاوي في أدائها على صوت داخلي مشحون بالانفعال والرقة، بينما يُشكّل مانجا البنية الإيقاعية والهارمونية للأغنية، من خلال تقنيات رقمية تتقاطع فيها التأثيرات الصوفية، الموسيقى التجريبية، وأحيانًا حتى أنماط التكنو البطيء (down-tempo).
في عروض “رَست”، لا يعود الطرب مجرد قالب سماعي، بل يصبح أداة بحث عن الذات، عن الذاكرة، عن المعنى، في عالم يتداعى ويتشتّت. هكذا، يُولد من هذا اللقاء بين الصوت العربي القديم والتقنية الحديثة نوع جديد من الغناء: غناء متحرّر، بلا جغرافيا، وبلا زمن ثابت.
بصوت بترا الحاوي المتأرجح بين الرقة والانفجار، وبالتركيبات الإلكترونية العميقة التي يصوغها هاني مانجا، يتحوّل ألبومهما الأخير “مسار“ إلى رحلةٍ صوتية مفتوحة، تتقاطع فيها الحكايات النسوية مع القلق الإنساني، ويغدو العرض برمّته مرآة حسّاسة لتجربة العيش على الهامش، حيث تنبع الأصوات من الداخل لتعيد رسم العالم من الخارج. ومعلوم أنّ هذا الالبوم صدر في 15 أبريل 2025 عن Thawra Records، كألبوم قصير من خمس مقطوعات، كلّ منها يعيد صياغة قصائد للشاعرة جنى سلوم بهدف تتبع تجربة المرأة العربية في رحلة طويلة من الضياع نحو التمكين.
رست، أصوات مبلّلة بالمسافة:
تولد موسيقى “رَست“ من شعور مزمن بالاغتراب، لا بوصفه فقط فُقدانًا للمكان، بل كحالة وجودية تتسلّل إلى اللغة والنغمة والصمت. أغنياتهم لا تحتفي بالحنين إلى وطن مفقود، بل تُفكّك فكرة الوطن ذاتها، وتطرح سؤالًا مفتوحًا: ما الذي يتبقى لنا حين تتشظّى الجغرافيا وتتهاوى المعاني؟
في موسيقاهم، لا نجد تصعيدًا دراميًا نحو الخلاص، بل انغماسًا جريئًا في القلق الإنساني، حيث يصبح الصوت طريقًا للحفر في الداخل، حيث تتجاور النصوص الشعرية مع الفراغات الصوتية، وتُستدعى اللغة لا للتوضيح، بل لخلق طبقة إضافية من الغموض الجميل. إن الاغتراب في تجربة “رَست” ليس فقط موضوعًا بل أسلوبًا، يظهر في طريقة بناء الجملة الموسيقية، في البطء المتعمَّد، في المساحات البيضاء بين النغمات، في ميلها للتكرار والانقطاع. إنهم يكتبون الموسيقى كما لو أنهم يكتبون رسالة من لا مكان، أو يصغون إلى مدينة لا تُسمَع.
“دياسبورا”: صوت الغربة المتحوّلة إلى غناء
تلامس بترا الحاوي في أغنية “دياسبورا“ من ألبوم مسار، جوهر الاغتراب لا كمكان بعيد فحسب، بل كإحساس داخلي عميق، يتسلّل إلى الذاكرة، إلى اللغة، وإلى الجسد نفسه. جاءت الأغنية كثمرة تأمل طويل في معنى الشتات، كأنها محاولة لتحويل التمزّق والبعد إلى مادة صوتية، يمكن حملها، بل ويمكن حتى الغناء بها.
كتب نص الأغنية بتركيبة شعرية كثيفة، وتدور حول الهوية المنفية، والبحث المستمر عن الجذور في أماكن غريبة، وعن صوت يشبهنا في مدن لا تُشبهنا. الأداء الصوتي لبترا كان متردّدًا بين الهشاشة والقوة، كأنها تمسك بجملةٍ وتُفلت أخرى، في محاكاة موسيقية دقيقة لحالة التمزق بين وطنين أو بين ذاكرة ونسيان.
تندمج في “دياسبورا” الآلات الإلكترونية الخافتة مع إيقاعات بعيدة المدى، لتخلق فراغًا صوتيًا يشبه المسافات بين المنافي. لا تصرخ الأغنية، بل تهمس، وتفتح نوافذ للتأمل لا للكلام. إنها ليست مجرد أغنية عن الغربة، بل تجربة غربة تُعاش بالصوت والنفس.
“رَست” ليست موسيقى المغتربين، بل هي موسيقى الاغتراب نفسه، كحالة يعيشها الجيل المعاصر: الجيل الذي كُسِر تواصله مع جذوره، ومع أوطانه، ومع اللغة أحيانًا، لكنه رغم ذلك يُصرّ على خلق صوت جديد، صوت هشّ، صادق، ومسكون بالتوق إلى وطن من موسيقى.
السارة والنوباتونز: أغاني الهجرة والنوستالجيا على ركح الحمامات
في سهرة من نوع آخر، اعتلت السارة أيقونة “النيوبان” رفقة فرقتها النوباتونز ركح الحمامات، محمّلةً بصوت يخرج من رحم النيل، ويعبُر إلى العالم محمّلاً بنبض الشتات.
اختلطت في حفلها إيقاعات النوبة، الفانك، الجاز، والإلكترونيك، لتخلق مزيجًا يُجسّد الشتات في بعده الجمالي، ويجعل من الحفل مساحة لاستعادة الهوية — لا كما كانت، بل كما يمكن أن تكون.
بإيقاعات النوباتونز التي تنهل من التراث السوداني وتعيد تقديمه في قالب معاصر، يمزج بين الريغي والإلكتروني والنغمات النوبية العريقة. بصوتها العذب، قادت “السارة” الجمهور في رحلة موسيقية من ضفاف النيل إلى مدن الشتات، حيث تتداخل الهوية بالحركة، ويصبح الحنين لغة مشتركة.
السارة والنوباتونز: رواية الحنين والهجرة بلغة النوستالجيا والإيقاع:
السارة بالإنجليزية (Alsarah) واسمها الكامل (Sarah Mohamed Abunama-Elgadi) هي مغنية سودانية–أميركية، عالمة إثنوميوزيك، ومؤلفة أغانٍ ذات صوت ثقافي راسخ. وُلدت في الخرطوم عام 1982وهاجرت طفلةً هربًا من الانقلابات السياسية في السودان نحو اليمن، ثم الولايات المتحدة، حيث نمت روحها الموسيقية في بوسطن ونيويورك.
أسّست في عام 2010 فرقتها (Alsarah & the Nubatones) إلى جانب شقيقتها ناهِد، وعزّافين من خلفيات إثنية متنوعّة تضم العود، الباص، والإيقاع الحديث. قدّمت مزيجًا موسيقيًا ميّزته بأنها نبع من التراث النوبي، مستعاد بروح معاصرة، تجمع بين الريفاكس الإفريقي والآليات الغربية المعاصرة. في أغنيات مثل “Manara” أو “Soukura”، بدا صوت السارة كنداء داخلي عابر للقارات، يُخاطب جمهور الحمامات كما لو أنه جمهور عالمي موحّد، يشعر بالغربة ذاتها، ويتوق للعودة نفسها، حتى وإن اختلفت الجغرافيا. وكان عرضها بمثابة سفر موسيقي عكسيّ، يعود فيه الجمهور من الغرب إلى الجنوب، من الإيقاع الصناعي إلى الجذور، ومن الغربة إلى الحنين.
غنت السارة عن الهجرة لا كأزمة، بل كحالة وجودية مركّبة: عن الحنين لما لم تعشه كاملًا، عن الوطن الذي لا يُشبه الخريطة، وعن الذاكرة التي تعيد اختراع نفسها في المنفى. تلبس كلماتها عباءة “النوستالجيا الذكية”، التي لا تستسلم للبكاء، بل تُعيد بناء الانتماء بالصوت، بالإيقاع، وبالرقص. إن الجميل في عرض السارة أنها لا تُغنّي للماضي، بل تُغنّي منه، وتُعيد تدويره في حاضر موسيقي معاصر، تتشارك فيه اللغة النوبية مع تقنيات المستقبل، وتتصالح فيه الذاكرة مع الإيقاع.
تكامل العرضين: تحرير الصوت والجسد والذاكرة:
بدا أنّ عرضي رَست والسارة والنوباتونز، رغم تباين شكلهما الفني، يتقاطعان عند جوهر مشترك: الرغبة في تحرير الصوت، الجسد، والذاكرة. لا يقدّم أيٌّ منهما موسيقى بالمعنى التقليدي، بل يطرح كل منهما سؤالًا وجوديًا مغنّى حول الانتماء، والحنين، واللغة، والذات الأنثوية .لم يكن العرض مجرد لقاء بين فرقتين، بل تجربة فنية مركّبة تتجاوز التصنيفات، وتفتح آفاقًا جديدة لفهم الموسيقى كأداة تفكير، وكتعبير عن واقع معقّد يتقاطع فيه المحلي بالعالمي، والتقليدي بالحديث، والمادي بالروحي.
تُعيد السارة بناء الوطن ليس من الجغرافيا، بل من الإيقاع، والنص، وطبقات الصوت المتعددة. العرض كان هادئًا، لكنه عميق، كأنّ كل نغمة تحمل معها عبقًا من أرض بعيدة، أو ظلّ أمٍ غائبة.
أما رَست، فاختارت العكس: الانفجار بدل التذكّر، الرقص بدل الحنين. على الركح، كانت الجسد، وكانت الصوت، وكانت الرفض. لغتها هجينة، عاميّة وفصحى، وإلكترونية في آن، تتقطّع ثم تعود، تتوهج ثم تختنق. في عرضها، لا تكتفي رَست بأن تُغنّي، بل تجعل من جسدها نصًا، ومن حركتها قصيدة تمرّد.
ورغم هذا التفاوت الظاهري، جمع العرضين تكاملٌ خفيّ: فـالسارة تُغني عن الوطن من بعيد، ورَست تصرخ داخل الوطن، كأنها عالقة فيه. تحكي السارة المنفى، وتفضح رست التقليد، فالأولى تسرد أما الثانية فتفجّر. وفي الحالتين، يكون الجسد حاضرا: عند السارة كأداة لاستعادة الذاكرةوعند رست كأداة للمقاومة. لا تخضع اللغة لديهما لقواعد النحو أو السوق، لكنها تكتب من داخل التجربة.
ريم خليفة
الحمامات، 15 جويلية 2025