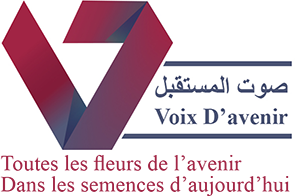رجاء بن عمّار فرسُ المسرحِ التونسيِّ الجموحُ

مقدّمة :
لقد رأى منظِّمو الدورة الواحِدة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدّولي للمسرح التجريبيّ أن يَخُصّوا عددا من الفنانين المسرحيّين العرب الذين غادرونا بفقرة يذكرونهم فيها ذِكْرًا بقرّون فيها لأفضالهم على مسار الحركة المسرحية العربيّة ويتجلّى هذا المقصدُ في إطلاق “ردّ الجميل” عنوانًا لهذه الفقرة التي امتدّت على يوميْن. وفي هذه الالتفاتة الرقيقة ما يَشي بسعى إلى بناء جسور بين المسارات التي عرِفها الفنّ المسرحِيّ في البلاد العربيّة، وما يَدلّ عن رغبة في السعي إلى الإقناع بالحاجة إلى الوعي بأهمّية تراكم التجارب في مجال هذا الفنّ تراكُمًا قادِرًا وحْده على بناء مسرح عربيّ متنوّع ومتعدّد. وما يؤكِّد ما ذهبنا إليه أنّ من اُحْتُفِيَ بهم قد فارقونا في تواريخ متباعِدة، ليست المتابعة التاريخيّة، إذن، هي الأساس الذي قام عليه هذا الاختيار فلقد غادرنا المغرِبي الطيب الصدّيقي 05 – 02 – 2016 والمصري عبد الرحمان عرنوس 01- 12 – 2009 والتونِسيّة رجاء بن عمّار 04 – 04 – 2017 و البحرينِيّ عبد الله السعداوي 03 – 02 – 2024. المنطق المتجلِّي هو السعي إلى حوار بين جناحيْ الوطن العربِيّ المشرقيّ والمغارِبيّ.
ولا يُمكنُني إلا أن أشكر المشرِفين على هذه التظاهرة على هذه المبادرة اللطيفة وأخصّ بالذّكر منهم رئيس المهرجان د سامِح مهران ومنسّق النّدوات الفكريّة د. محمد سمير الخطيب. ولقد طلبا منّي أن أتكلّم عن رجاء بن عمّار في هذا الإطار، وما كان لي أن أتردّد لحظة واحِدة في الاستجابة إلى طَلَبِهما لتقديري لهذه المبادرة وما تعنيه، من ناحِية، ولكَبير تقديري، من ناحية أخرى، لرجاء بن عمّار ولأمسيرتها المسرحية وللأثر الذي تركته لا في المسرح التونسيّ والعربيّ، فحسب، وإنّما في ما مثّلته من نموذج فريد للفنانة التي اختارت أن يملأ الفنُّ حياتها كلَّ حياتِها وللصورة النّاصِعة التي مثّلتها للمرأة التونسيّة المناضِلة من أجل تحقيق ذاتها والسعي إلى حياة أجمل وأفضل لأبناء وطنها وللإنسان في أيّ مكان كان.
تإطار هذا النّ وتطلّعاته:
بعد التعبير الوجداني من طرف كلِّ من عرِف الفقيدةَ من قرب أو من بُعد عن حُرقةَ الفقد وألَم الثّكل من الضرورِيّ أن يقوم خطابٌ آخر هي أهلٌ له. فغالِبًا ما ازدوجت أشكالُ التّعبير الوِجدانِيّ ذاك ( وهو أمرٌ طبيعِيّ) بحالةٍ أقرب ما تكون إلى صُوَرٍ من “التطهير” يُرافِقه خطابٌ يغلُب عليه الشُّعور بـالظلم الذي قد يتحوّل إلى خطاب “مظلومِيّة”. فكيف يُمكِن أن يَقبَل المرء غياب من كانت تمثّل الحياة بكلّ ما تعنيه من دفق وحركية وفِعْلٍ يقوم في جوهره على حبّ لعيش الحياة ودّعوة إليها وسعي إلى دفع النّاس إلى ترقيتها إلى مصاف الحقوق التي لا يُمكن التنازُل عنها.
وقد يكون من الطبيعِيّ أن يُبرِز الخطابُ ما حُرِمت منه الفقيدة من الاعتراف بالمكانة وبالمُنجز وتُحمّل السّلَطُ كلّ السّلط الفِعليّة منها والتجريديّة مسؤوليّة ذلك كلّه. ولئن كان مِثل هذا الخِطابُ مشروعًا، بحُكم تقصير السّلط كل السُّلط مهما كانت، فإنّه قد يسقط هذا الخِطاب في الكلام العام الذي لا يكاد يغيب عن حالات الفقد مهما كان الفقيد، وقد تُغطّي غلبة خطاب “المظلوميّة” ذاك – سماتٍ هي الأبرز -حسب رأيي- في الفقيدة. لقد حظيت الفقيدة بتقدير السلطات والمؤسّسات الرسميّة وغير الرّسميّة فنالت – عن اقتدار- النياشين والجوائز والتكريمات في تونس وخارِجها. لم تُحرمْ الفقيدة من صور الاعتراف المُستَحقّ وهو ما يعني أنّ خطاب المظلومِيّة بغمطها حقّها في ما اتسمت به وفي ما اختارت أن تكون. إنّ قيمة الفقيدة لا تتجلّى من خلال خطاب المظلومية ذاك، وإنّما من خلال البإشادة بأنّ هذه الاعترافات والجوائز والنياشين كلّها لم تجعلها تقف عن مواصلة جهدها في تحقيق ما كانت تسعى إليه على مختلف الأصعدة الفنيّة الذّاتيّة منها والجمعية.
يسعى هذا النّص إلى الإسهام في الوقوف على أهم ما ميّز مسارات الفقيدة ورسم المسالك التي قامت عليها مُنجزاتُها. لعلّ في ذلك شيءًا من الوفاء لها وعملاً جادًّا في إبراز سمات ما قامت عليها تجربتها الفنّيّة والوجودية.

نصّ المُداخلة:
رجاء بن عمّار فرسُ المسرحِ التونسيِّ الجموحُ
رجاء بن عمّار فنّانة مسرحيّة شاملة (ممثّلة-راقصة، ومخرجة ومؤلّفة عروض فنّيّة) تحتلّ موقِعًا لا يُنْكَرُ في الحياة المسرحيّة التونسيّة بمـُخْتَلَف مُكَوِّناتها، لا من خلال الآثار الفنّيّة التي أنجزتها، فحسب، وإنما من خلال المسارات التي اتبعتها فيها، بشكل خاصّ. ولقد عُرِفَتْ رجاء بن عمّار، إلى جانب ذلك، بشخصيّتها القويّة وبروحِها القيادِيّة وبِطاقتها الفيّاضة وباندفاعِها في كلِّ ما تنخرِط فيه من أعمال ومشاريع وفي كلّ ما تذهب إليه من آراء ومواقِف. ولم تَكُنْ لتتردّد في خوض المعارك التي قد تنجَرّ عن ذلك كلّه.
ولعلَّنا لا نُجانب الصّوابَ إذا ما رأيْنا فيها صورةً لجيلٍ من أجيال تونس الحديثة، عامّةً، ولصِنْفٍ من النّساء التونسيّات فيه، خاصَّةً. ولقد تجلّى ذلك في انشغالها عميقًا، وهي تمارِسُ فنَّها الذي مثّل كلَّ حياتِها، بِما كان يحصُل في البلاد، من ناحية، وفي انفتاحها في الآن ذاته، من ناحية أخرى، على ما كان يَجِدُّ في العالم في مجال المسرح وفنون العرض من مُنجزات وفي سَعْيِها إلى استيعابها استيعابًا خلاّقًا. ولئن كان للمدرسة العموميّة التونسيّة وامتداداتها وللتحوّلات التي عَرِفَتْها البلادُ، منذ الاستقلال، ما قد يُفَسّر أبعادًا هامّة في ميزات رجاء بن عمّار، فإنّ للمسار الشخصيّ الذّاتيّ، كذلك، أَثَرًا فيها، لا يُمكِن طمسُه، خاصّة إذا ما انتبهنا إلى بعض المنعرجات التي قامت فيه.
وُلِدت رجاء بن عمّار في تونس العاصِمة 01 أكتوبر 1954 في عائلة متوسّطة، كان أبوها يَشتغل في مجال الصحّة العمومية وأمُّها بشؤون المنزل؛ وكانت أكبرَ إخوتها. إلا أنّها كانت ر وثيقةَ الصِّلة بالفنّ والفنّانين، منذ طفولتها، فلقد كان أخوالُها من بين أهمّ الموسيقيّين في تونس، وقتَ طفولتها وبعدها. وأشهرُهم هو رضا القلعي (1931- 2004) المُلحِّن وعازف الكمان ومؤسِّس (سنة 1948) فرقةِ المنار الشهيرة؛ وكذلك عازف العود والمـُلَحِّن الذي لا يَقِلّ عنه شهرةً أحمد القلعي (1936 – 2008). ولعلّ في هذا ما يُفسّر شيئًا من تقديرها للفنّ والفنّانين ومن إيمانها بِدَوْره ودوْرِهم في جعل حياة النّاس أفْضَلَ.
زاوَلت تعلُّمَها في المدرسة العموميّة وتخرَّجَتْ من مدرسة ترشيح المعلّمات، سنة 1973 بمعدّلٍ فتَحَ لها البابَ للالتحاق بدار المُعلّمين العليا التي كانت، في ذلك العهد، من بين مُؤَسَّسات التعليم العالي المرغوب فيها، وتوجّهت لدراسة الآداب الفرنسيّة؛ إلا أَنَّها اختارت أن لا تُواصل مسارَها التعلُّميّ العالي إلى آخِره، وفضّلت الالتحاقَ بالمسرح وعوالمه التي سبق لها أن انغمست فيها من خلال اندراجِها في نشاطات المسرح المدرسيّ الذي برزت فيه ونالت من الجوائز ما لَفَت الانتباهَ إليها من قِبَل المسرحيّين التونسيّين والمعنيّين بِالثقافة في البلاد. وهذا منعرَجٌ أساسيٌّ في حياة رجاء بن عمّار. ولقد ازدوج هذا المنعرجُ بآخر تمثَّلَ في زواجِها، سنة 1975، بالفنّان المُنصف الصايم ( 1949 – = ) المتخرّج هو الآخر من مدرسة ترشيح المعلّمين والحائزُ على جوائز في المسرح المدرسي أهّلته إلى الاندراج في الحياة المسرحيّة التونسيّة الاحترافيّة، منذ تخرُّجِه؛ فلقد اندرجت رجاء بن عمّار، بعد زواجِها، في مشروع حياة احتلّت فيه المشاريعُ الفنِّيّة موقِعًا جَوْهَرِيًّا ولعِبَتْ فيه دورًا مُحَـدِّدًا. ولقد تجلّى ذلك، أوّلَ ما تجلّى، في استكمال تكوُّنِها الفنِّيَّ، مَع رفيق دربها، في مجالات المسرح وفنون العرض في ألمانيا، على خلاف أغلب رفاقهما، ولقد شكّل حصولـُهما على مِنحة مَكَّنَتْهما من الالتحاق بِإحدى جامعات مدينة ميونِخ München والبقاءِ فيها، مُدّةً ناهزت السنة (1975 – 1976) مُنْعرَجًا حاسِمًا في المسار الذي سيرتسم لِرجاء بن عمّار في ممارستها الفنّيّة. وكانت هذه المدّة كافِية للتشبّع بالحراك الفنّي في تلك المدينة وفي غيرها من مُدُن ألمانيا؛ فلقد أُتيح لها أنْ تواكب الحياة المسرحيّة الألمانية بكلّ رغبة وَنَهَمٍ وأن تكتشف بكل انبهار آفاقًا فكريّة وفنّيّة أخرى للمسرح لم تكن في الحسبان، وأن تقف، كذلك، على منطق في سير المؤسّسات المسرحيّة وتسيِيرها لم تكن تعْرِفه. وستتوفّر لها ولرفيق دربها، فرصةٌ أُخرى سنة (1991) للعودة إلى ألمانيا، بعد مرور خمس سنوات عن زيارتهما الأولى وبدء اندراجِهما في الحراك الذي كان قائمًا، وقْتَها، في المسرح التونِسيّ؛ وتمثّلت هذه الفرصة في استضافتهما “استضافةً فنّيّة” لمدة ستّة أشهر متّصلةً من طرف الفرع الألمانيّ للمعهد الدوليّ للمسرح وبدعم من السلطات الألمانيّة؛ ولقد كانت لهما، الحُرّيةُ في اختيار ما يشاءان من العروض وزيارة ما يريان من المؤسّسات المسرحيّة، فتحقّق لهما ما يسمح بتعميق صلتهما بالحياة المسرحية الألمانيّة وبأهلها ومساراتها وبترسيخ بعضٍ من التوجّهات التي تجلّت في أعمالِها وتطلُّعاتها. ولا تكادُ تُخفي رجاء بن عمّار الأثرَ البالِغَ الذي تركته فيها مُعايشتُها للحياة المسرحية الألمانية في هاتين المُناسَبَتيْن، وهذا بيِّنٌ في الحَيِّزِ الذي خَصَّتْهُما به في ما دوّنته في سيرتِها الذّاتيّة المكتوبة باللغة الفرنسيّة (والممتدّة على صفحتيْن)؛ ففي حين اقْتَصَر تقديمُ تَكَوُّنِها المدرسيّ الأساسيّ على أقلَّ من سَطْرٍ واحِدٍ (“دار المعلِّمين العليا، فسم الآداب الفرنسيّة”)، خصّصت ما يٌقارب رُبْعَ الحَيِّزِ الذي قامت عليه سيرتُها الذّاتيّة لِتفصيل القول في ما عاشته في ألمانيا في المناسَبتيْن، تدقيقًا لأسماء المؤسّسات التي زارت وتحديدًا لأسماء من تواصلت معهم من الأساتِذة والفنّانين. فذكرت – إضافة إلى تعلّم اللغة الألمانيّة في معهد غوته وجامِعة ماكسيميليان Maximiliansuniversität – مدرسةَ “روث فون زربوني” Ruth Von Zerboni الواقعة في “قاوتينق”Gauting إحدى ضواحي مدينة “ميونيخ” (وهي مدرسة عريقة، تمتدّ الدراسة النّظامِيّة فيها على ثلاث سنوات)، ودقّقت موضوع الدّورة التدريبية التي اتّبعتها فيها (الدراماتورجيا وبناء الشخصيّة) ؛ وذكرت، عند استعراضِها للدورات التدريبية الأخرى التي تلقّتها ولِلِّقاءات الفنّيّة التي أجْرَتْها، أسماءَ عدَدٍ من الفنّانين والفنّانات الذين أسْهَموا في بناء المسرح الألماني ورسموا مساراتٍ في فنون العرض الجديدة، شأن المخرِج مانفريد فيكفارث 1929 – 2014 Manfred Wekwerth مدير “البيرلينير آنسامبل” (1977- 1991) Berliner Ensemble، والمـُخْرِجُ النمساوي “كارل باريلا” ( 1905-1996) Karl Paryla الذي اشتغل مع بريشت وعايشه في منجزاته ومحنته، ومانفريد بايلهارتز Beilhartz مدير مسرح مدينة “كاسل” Kassel وبدت عنايةُ رجاء بن عمّار مُنْشَدَّةً انشدادًا واضِحًا، إلى “التانزتياتر” Tanztheater [الرقص المسرحيّ] وإلى أساطينه في تلك الفترة فلقد ذكرت كُلًّا من الكوريغراف [مُصمّم الرقصات] William Forsythe مديرِ أوبرا فرانكفورت Frankfurt وكريزنييك Krysnieck مدير مسرح مدينة بريمن Bremen و برزت من بَيْن مَنْ ذكرت من الأسماء “بينا باوش” (1940- 2009) Pina Bausch مديرة مسرح “فوبيرتهال” Wupperthal بروزًا لافِتًا. ومعلومٌ هو الموقِع الذي احتلّته “بينا باوش”، عند أغلب الباحثين والمؤرّخين، في بناء ما قام عليه الرقص المعاصِر ومعلومٌ هو الاعتراف لها بِتَثْوِيـر فنِّ الرّقصِ عامّة، وابتداعِ الـ”تانزتياتِر” الذي يلتقِي بِالمسرح من حيث الإحالة في عُروضه، على مشاهد ووضعيّات من الحياة اليوميّة للناس، من ناحِية، والتعويل فيه، من ناحية أخرى، على جسدِ الرّاقِص وطاقاته المـُطْلَقة، بدَلًا عن الاقتصار عند تصميم العروض على التّوليف بين “خُطوات الرقص” المـُحَدَّدَة.
ولا نرانا مجانبين للحقيقة عندما نذهب إلى أنّ “بينا باوش” وما مثّلته قد كانت النموذجَ المـُـبْهِرَ والمـُشْتَهَى الذي لن يغيب عن ذِهن رجاء بن عمّار وعن شواغِلها والذي سيقود تطلّعاتِها الفنّيّة. فإلى جانب كوْن “بينا باوش” فنّانةً فتحت آفاقًا جديدة في فنّها فهي، كذلك، امرأةٌ استثنائيّة ذات طاقة فيّاضة نجحت في فرض ذاتها فرضًا؛ ولعَلَّنا واجِدون في انبهار رجاء بن عمّار بـِ “بينا باوش” مفاتيحَ لفهم بَعْضٍ من المنطق الذي خضع له مسارُها الفَنِّيُّ وقاد مشاريعَها وأعمالَها إلى آخر نَفَسٍ في حياتها. ولعلّنا واقِفون، كذلك، على السّرّ في المعارك التي خاضتها، سواء منها التي تجلّت في رفع تحدّيات قامت على صعيدها الشخصيّ، أو في تجاوز العراقيل التي كانت قائمة على مستوى واقِع المسرح وفنون العرض في تونس، ثقافَةً ومؤسّساتٍ.
لقد كان على رجاء بن عمّار المـُمَثِّلة التي اكتشفت “الرّقص المسرحي”، وقد اشتدّ عودُها، أنْ تتحدّى العوائق النّاجِمةَ عن تأخُّرِ اكتشافها له وتعلُّقِها بِه؛ وذلك لأنَّ “الرَّقص المسرحيّ” هو، قبل كلّ شيء، رقصٌ يُنْجِزُه راقِصون متمَكِّنون من أدوات فنِّهم، حتى وإن ارتبط بصورة من الصُّور بالمسرح. و”بينا باوش” راقِصةٌ مكتملةُ التكوّن في مجالها و”كوريغراف” خبَرت فنون الرقص مُمارسة وتنظيرًا، مدّة من الزمن ليست قصيرة؛ وما أنجزته في مجال “التانزتياتر” هو في صميم فنّ الرّقص ومرجعيّاته وأدواته. واكتسابُ المهارات البدنيّة والفنّيّة التي يتطلّبها فنُّ الرّقص، يَنْطَلِق بالنّسبة إلى من يحترِف هذا الفنّ، منذ الطفولة، ويَستَمِرُّ تعهُّدُ تلك المكتسبات وتطويرُها بانتظام وانضباط. لقد تطلّب من رجاء بن عمّار إدراجُ الرقص المسرحِيّ ضمن شواغل المـُمثّلةِ التي كانت أن تخوض معْرَكَةً مع نفسها فَتْعَمَلَ، جاهِدةً كلَّ الجهد، على اكتساب المهارات التي تسمح لها بأن تُصبِح “مُمَثـِّلة – راقِصة”، وهي الصّفة التي تصف بها نفسها في سيرتها الذّاتيّة وبها تُعرّف مهنتها. ولقد حقّقت، في معركتها هذه، على صعوبتها، انتصاراتٍ تجلّت، من ناحية، في تطويرِ أدواتِ تعبيرِها في ما أدّت من أدوار، بعد عَوْدَتها إلى تونس، وفي نوعيّة الأعمال المسرحيّة التي أنجزت تَصَوُّرًا وإخراجًا، من ناحية ثانِية. ولعلّ أهمَّ نقلةٍ نوعيّة حصُلت لها من وراء معرَكتها هذه، هي تنزيلها الجسدَ عامَّةً والجسدَ في عمل الممثّلين، خاصّة، موقِعًا أساسِيًّا في عَمَلِها وفي نِظْرتها للمسرح وتجلّياته. ولم يَعُد غريبًا، بعد ذلك، أن تتحوَّل إلى داعية إلى هذه الرّؤية، كلّما أُتيحت لها فرصةُ الكلام في المسرح أو العمل فيه، إلى درجة أنْ أُقِرّ لها برسالتها تلك فطُلِب منها أنْ تُشْرِف، أكْثَرَ من مرّة، على ورشات لتدريب المُمثّلين والمـُمثِّلات، في البلاد التونسيّة وفي عدد من البلدان العربية.
أمّا عن أثر هذه النُّقلة النّوعيّة في المسارات التي اتّبعتها رجاء بن عمار في أعمالها المسرحيّة فإنّها واضِحة كلّ الوضوح ويكْفي، للتّاكُّد من الأمر، أن نُقارن بين عرض “تمثيل كلام” الذي أنْجَزَتْه فرقة “مسرح فو” (التي أسّستها، سنة 1979، مع المنصف الصايم وتوفيق الجبالي وعبد الرؤوف بن عمر ورؤوف الهنداوي)، سنة 1980 وبين “باب النجوم” العرض المـُنجَزِ سنة 2008.
لقد قام العملُ الأوّلُ على الكلمة وهذا جليٌّ في عنوان العرض الذي وضَع الـ “كلام” موضع المركز وإليه أضاف الـ “تمثيل” باعتباره منطلِقًا منه وآيلًا إليه، وهو واضِحٌ، كذلك، في اسم الفرقة ذاتها الذي أبرزَ الفمَ [النّاطِقَ بالكلام] وإليه نَسَب المسرحَ فبدا ذلك بمثابة مشروعٍ فَنّيٍّ يَجْمع بين مؤسّسي الفِرقة ويَرْسُم ما يُميِّزُهم وبدا هذا العرض تجسيدًا لذلك المشروع. أمّا العرض الثاني “باب النجوم” فأُرْفِق، عند الإعلان عنه بكونه “installation/performance/théâtre déambulatoire” [تنصيبة / عرض أدائي / مسرح التِّجوال]، ولا يَخْفى، في هذا التعريف، الإعلانُ عن سعي إلى الخروج، في هذا المٌقْتَرَح الجمالِيّ، عن المسرح رغم شيء من التمسّك بالانتماء إليه، ونِيّة الخروج عن المسرح بَيِّنٌةٌ في تعدّدِ الأجناس الفنّيّة التي نُسِب إليها هذا المقترحُ الجَمالِيُّ؛ وهذا التعدُّد لا يخلو من حالة ترَدُّدٍ في ذهن صاحبة العرض تجلّت في صلة التجاور بين الأجناس المعلنة دون الوَصْل بينها؛ والجامِع بين الجنسيْن الأوّليْن نَفْيُهما للكلام حِوارًا أو سردًا وتغييبُهما للدراما بِنْيَةً وأساسًا للتفاعل والتواصل مع المـُتلَقِّي. أمّا سِمة التّجوال التي وُسِمَ بها المسرحُ في هذا التعريف فلا تُعْلن عن نوعيّة من المسرح وإنّما تتعلّق، في حقيقة الأمر، بموقِع الجمهور المتلقّي مِن مكوّنات العرض المـُقْتَرَح عليه. فلقد قام هذا العرضُ على مجموعة من التنصيبات زُرِعت في مواقِع مُختلِفة من مباني المركز الثقافي بالحمّامات وحديقته، وقامت التنصيبات على اختِزال مشاهد تراوحت مكوّناتُها بين عناصر ساكنة وأخرى مُتحرّكة وبين مشاهد صامتة وأخرى مليئة بالأصوات، كلامًا مُعادًا، وغناءً وضجيجًا يتداخل فيها الحُلْمُ المـُزْعِج باليومِيّ المـُتكَرّر مع إحالات على واقع الناس وحياتهم. وكان على الجمهور أن يقادوا إليها الواحِدة بعد الأخرى في مسلكٍ رأت صاحِبَةُ العرض أن تكون نهايتُه الساحةَ الواقعة وراء الركح الدّائرِي لمسرح المركز الثقافيّ، لا خشبة ذلك الرّكح، إمعانًا منها في إعلان الخروج عن المسرح، دون الخروج عنه. وبين هذين العرْضيْن عدد هامّ من العروض نقف فيها على سعي إلى التّضئيل من شأن الكلمة وإدماج الرقص في تلك العروض المسرحيّة إدماجًا أصبح، في كثيرٍ منها، عُنصُرًا من بِنْيَتِها عليه تقوم. ولقد عوّلت رجاء بن عمار، في ذلك، على دعوة عدد من الخبرات التونسيّة في مجال الرَّقص التقليديّ منه والمعاصر للإسهام في هذه العروض من موقع الراقضين أو من خلال وضع خبرتهم على ذمة الممثلين والممثّلات ومن ورائهم العرض المسرحي المقترح. كذا كان الأمرُ، مَثَلاً، في مسرحيّة “الأمل” سنة (1986) عندما دعت “خيرة عبيد الله” الراقصة الأولى في فرقة الوطنيّة للفنون الشّعبيّة بصفتها خبيرة في الرقص الشعبِيّ، وكانت فيها مع آمال الهذيلي الممثلة والراقصة؛ وكذا كان الأمرُ في “بستان جمالك”، سنة (1987)، عندما عوّلت على الكوريغراف البولوني ريموند سوبيتشاك Raymond Sobitchak وفي “مجنون غرناطة” ثم في “سلام بومباي”، سنة 1990، مع الرّاقصة الكوريغراف إيمان السماوي وفي “ليلة بيضاء” (1992) و”ريّا وسكينة”سنة (1995) مع الراقصيْن الكوريغرافيّين عماد جمعة ونجيب خلف الله.
أمّا معارِكُها الأخرى فارتبط أهمّها بالحراك الذي عاشه المسرح في تونس، مؤسَّسةً وهياكِلَ. لقد كانت حاضِرة، حضورًا فاعِلاً مع “المسرح الجديد” في “التحقيق”، سنة 1977، إحدى مسرحيّات هذه الفرقة المرجعيّة؛ واندرجت، من ثمّة، في إطار معركة المؤسّسات المسرحيّة المـُستقلّة عن الإدارة العموميّة من حيث تسييرها والمـُرتبِطة بها ارتباط تَعاقد حول مشاريع. وعلى هذا الأساس، كانت رجاء بن عمار طرَفًا في تأسيس فرقة “مسرح فو” التي استَقلّت بها مع المنصف الصّايم وأنجزت في إطارها أعمالها المسرحيّة وفَرَضَت وجودها باعتبارها مؤسّسة فنّيّة لها حضورها بين المؤسّسات العمومية والمستقِلة الأخرى القائمة منها والنّاشِئة وقتها. ثم خاضت، بعد ذلك، معركة الفضاءات المسرحية، إثر نجاح توفيق الجبالي في إنشاء فضاء “التياترو” المُستَقِلّ مستفيدًا من بعض الفصول القائمة في قانون الماليّة التي تفرض صرف نسبة من مرابيح المؤسّسات لتمويل الأعمال الفنِّيّة؛ فتقدّمت بمشروع لاستصلاح قاعة سينما على ملك بلديّة قرطاج، كانت مهجورة، لتحويلها إلى مسرح وفضاء ثقافِيّ شامِلٍ. ولئن نجحت هي ورفيق دربها في الحصول على موافقة مجلس البلديّة، سنة 1994، فإنّ الأمر لم يستقرّ على حال، فلقد تراجعت البلديّة، بعد أن تمّ الانطلاق في تهيئة قاعة “مدار” (وهو الاسم الذي أطلقاه عليها)، وطالبت باسترجاع القاعة، ولم يكُنْ الأمرُ في غير صلة بتمسّك رجاء بن عمار والمنصِف الصّايم باستقلاليّتهما وبعدم الخضوع لابتزاز الساسة ومواجهة “شعبة” الحزب الحاكم التي كان تقيم في جزء من مبنى القاعة، إضافة إلى جشع بعض ممّن يرون في الأرض الواقع عليها مسرح “مدار” غنيمة يمكن أن تدرّ أرباحًا ضخمة إذا ما خضعت إلى منطق المضاربات العقّاريّة. وتجلّت في خوض رجاء بن عمار هذه المعركة القانونيّة والإعلاميّة صُوَرٌ أخرى من صلابتها ورباطة جأشِها وتأكّدت قدرتهُا، خاصّة، على تجنيد الفنّانين والمـُثقّفين والمجتمع المدني للوقوف إلى جانبها وجانب مشروعها الفنّي والثقافي. فلقد نجحت في تحويل قضيّة “مَدار” إلى قضيّة رأي عام. ولئن كسبت القضية قانونِيًّا في المحكمة الإدارية بعد أكثر من ستّ سنوات، فإنّ ذلك لم يُنْه مظاهر التعطيل التي كانت تطال “مدار” ومشاريع رجاء بن عمّار الفنّيّة والثقافيّة؛ غير أنّ ذلك لم يَفتّ في عزيمتها فاستمرّت في المواجهة دون أن تكفّ عن إنجاز مشاريعها الفنّيّة والتّثقيفية.
ولقد حَظِيَتْ رجاء بن عمّار و أغْلَبُ أعمالِها المسرحية بالتقدير في تونس وخارجها، من خلال اعتراف المؤسّسة الثقافية الرّسمية التونسيّة بقيمتها (جائزة الثقافة والفنون سنة 1993؛ وسام الجمهورية سنة 2000 ) ومن خلال الجوائز التي حصلت عليها في أهم المهرجانات والتظاهرات الفنّيّة (جائزة أفضل مُمَثِّلة في “أيّام قرطاج المسرحيّة” دورات 1987؛ 1989؛ 1995؛ 1999 والجائزة الكبرى في دورة سنة 1995من نفس المهرجان. جائزة أفضل عمل مسرحيّ وأفضل إخراج وأفضل ممثِّلة سمة 1989 في “مهرجان القاهِرة الدّوليّ للمسرح التجريبي” …) ولم تكُن لحظات البهجة التي عاشتها مع كلّ نجاح تُحقِّقُـه لِتُلْهيها عن استئناف العمل وعن رسم مشاريع جديدة وكأنّ في ذلك وحده ما يُحقّق لحياتها معناها.
لقد خَبِرت رجاء بن عمّار من خلال مسارِها الفنّيّ الذي تَمَاهى أو كاد مع حياتها كلّها، المسرَحَ وعَمِلَت على أن تكون سَيِّدةَ خطابها فيه، وخاضت عددًا هامًّا من المعارك سواءً منها تلك التي عرفها المسرح في تونس أو تلك التي بدت لها مصيريّة باعتبارها امرأةً وامرأةً فنّانةً تحقَّقَت لها في تونس الحديثة من المكاسب ما يُحمّلها مسؤوليّةَ تَطْويرِها والدِّفاع عنها بكلّ شراسة، ولم تتوانَ، عند قيام الثورة في تونس، عن الاندراج فيها إلى جانب المثقّفين الوطنيّين اندراجًا مباشِرًا وفاعِلاً. ولقد كتبت رجاء بن عمّار نصًّا ألقته في مدينة عمّان، وسمته بـِ : ” مفاتيح للتكوين، منحتها لي الثورة” تفاعلت من خلاله مع الثورة في تونس وفي البلدان العربيّة تفاعُلًا واعِيًا اتّسم بالحماس والاندفاع لكنّه لم يَخْل من عمق وتواضع في الآن ذاته، تَوَضُع الفنّان عندما يتحوّل إلى منصتٍ لأصوات من لا صوت له مسموع وإلى باحث في الأحداث الجسام عن جوهر ما في الإنسان وعن أجمل ما يُمكن أن يتحقّق في مجتمعات الناس إذا ما تحوّلت الخصوصيّةُ الخاصَّةُ إلى انفتاحٍ على الكوْن بِأسْرِه. لقد عكَس هذا النّصّ من خلال جُمـَله المتقطّعة حينًا والمُسترسِلة، أخرى، ومن خلال استطراداته المـُلتفّ بعضها على بعض وبتضميناته المتنوّعة المـُتَداخلة وبِنَفَسه الحالم، أحيانًا كثيرة، صورةً لرجاء بن عمّار المُنغَرِسة في أرضِها وعصرها والحالِمة بالأفضل والدّاعية إليه.
محمد المديوني
المصادر والمراجع:
– بن عمّار، رجاء (نقلها إلى العربيّة منصف الصّايم)، مفاتيح للتكوين، مَنَحتها لي الثورة. نصّ مرقون في 12 صفحة.
– بن عمّار، رجاء، سيرة ذاتيّة (باللغة الفرنسيّة).
– بن عمّار، رجاء، عدد من الأحاديث الصحفية أدلت بها إلى وسائل إعلام مكتوبة ومرئيّة.
– المديوني، محمّد، مُغامرة الفِعل المسرحِيّ في تونس، سحر للنّشر، تونس، 2000.